جزاك الله خيرا يا هادية... في الحقيقة، اغتنمت فرصة تفرغي الأسبوع الفارط، وقرأت للدكتور أربعة كتب، هي على التوالي: "رأيت الله"، و"الوجود والعدم" و"من أسرار القرآن" و"محمد" .
الوجود والعدم، عنوانه أيضا شدّني ....
يبدأ بالفصل الأول "
التعرف على ملك الملك"
ويستهلّه الكاتب بمقدمة جميلة جدا، عن عدم إمكانية قلب الحب كرها، أو الكره حبا، وأنه لو تحالف الحديد والنار والسجن والتهديد على سجين لما استطاعت جعله يحب ما يكره، أو يكره ما يحب ...
ذلك أنه في أعمق الأعماق روح أعتقها الله من كل القيود ...وصولا بهذا إلى أن كل وسائل الإصلاح التي تعتمد على القهر والتعذيب، والقوة تفشل....وأنّ الإنسان إذا ما تعلق بربه، وكان نبض حياته مع الله تعالى، وأيقن أنه لا حاكم غيره، ولا فاعل سواه، ولا مقدّر غيره، ولا مصدر للحياة والحب والخير غيره سبحانه، أصبح بمعيّة الله لا يرى قوة ولا فعلا إلا منه سبحانه .... فالله هو الذي يسقيه وليس الماء، والله هو الذي يطعمه وليس الخبز، وإنما كلها أسباب سخّرها سبحانه لعباده ....
يَذهب بذلك الإدراك من العبد بوحدانية الله تعالى وفعله وأمره وقدرته ووجوده كلُّ الخوف من كل مخيف، ويوحد العبد ربه، ويصف الكاتب هذا بـ"الأثر البنائي للتوحيد على شخصية الإنسان" ....وأن الوحدانية هي السقف الذي يحمل الكون، ويحمل شخصية الإنسان ...
ثم يسوق آيات قرآنية سوقا جميلا كلها تقرّر وحدانية الله تعالى، وفساد الكون لو كان معه الله إله سواه ، وتقرّ بطلان من قال أن له ولد، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا... ويستطرد في الحديث عن وحدانية الله تعالى، ثم يطرح سؤال السائلين :
فإن كان الله هو المنفرد بالضر والنفع فما دور الأسباب الظاهرة مثل الميكروبات والأمراض، كيف هي تضر ونرى العقاقير تنفع وتشفي ؟
ويجيب أن الأسباب لله، هو الذي يؤتيها، وهو مالكها، وهو الذي يسوقها، وهو الذي أقام قانون السببية ...وهي لا تضر ولا تنفع بذاتها، بل هي مظهر لمشيئته تضر بإذنه، وتنفع بإذنه ....ثم يسوق آيات من كتابه المسطور سبحانه تدليلا على عظمة فعله في كتابه المنظور ...
كما يبين أن مقاليد الإيمان والهداية بيد الله وليست بيد أحد من عباده، حتى الرسل، ولكن هذا لا ينفي مسؤولية العبد، بل إن مشيئة الله وهدايته تستند إلى استعداد في العبد ...
** فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
**فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضا
وهكذا يستطيع العبد أن يخطو للنور فيتلقى النعمة، أو للظلمة فيُحرم، وهذه التوجهات القلبية حرة بيد صاحبها ....
ثم يأتي الفصل الثاني من الكتاب بعنوان "
الوجود كله لله"
يعود فيه للتفصيل في مسألة التوحيد، وتعدد القوى ظاهرا على ما ترى العين، وأنها كلها من الله تعالى، فالإنسان إذا وصف قال: نزلت صاعقة في المكان الفلاني .... وهبت الريح، ونزل المطر....أما القرآن فيسنده كله لله تعالى :
**فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
**وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ
وبالتالي من الطبيعي أن يصرف القرآن الإنسان إلى عبادة الله وحده ...
ثم يطرح السؤال الذي كان وما يزال هو سؤال الكثيرين : إذا كان الله هو الفاعل لكل شيء، فماذا يبقى للعبد من فعل؟ وعلامَ يحاسب؟ وفيمَ يسأل؟
ويبين أن هذه الكثرة الظاهرة الفاعلة قد أودعها الله الفعل ظاهرا مخفيا فيها مشيئته سبحانه، وتنضوي هذه الكثرة في وحدة هي الأمر الإلهي لا يتخلف عنه أحدها ....
ويبين أن الكل طوع أمره مع كثرة الظواهر الطبيعية، القوى المادية والملائكة والملأ الأعلى، أما الإنس والجن والشياطين فمخيّرة تطيع وتعضي عن اختيار، ولهذا جعلها الله محل مؤاخذة ومحاسبة وعقاب .
ثم يطرح مصطفى محمود مع هذه القدرة المطلقة لله تعالى والفعل والأمر، يطرح فعل العبد، وكيف أن القرآن يسند أيضا العمل للعبد صراحة في آيات عديدة،
"وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً"
"إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ"
وغيرها من الآيات التي يسوقها ......
فيقول أن هذه الازدواجية في إسناد العمل لله، وإسناد العمل للعبد، تكمن في أن الله أقام الإنسان خليفة في الأرض، ونفخ فيه من روحه، وسخّر له الطبيعة وطوّع له القوانين، ومكّنه من العمل ....والإنسان على وفق هذا يعمل بتفويض وتوكيل وله حرية الطاعة والمعصية ...وهو مسؤول في نطاق هذا التكليف .
لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا والله بهذا يسهل للعبد إنفاذ ما أضمر في نيته، إن خيرا فتيسير خير، وإن شرا فتيسير شر...ويورد على هذا آيات منها :
فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى(5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى(6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى(7) وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى(8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى(9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى(10) -الليل-
يقول:
الله يسيرك إلى عين اختيارك، فلا جبر ولا إكراه ولا وجود لإرادتين متنازعتين، بل مشيئة واحدة، فالله يشاء لك عين ما شئت لنفسك وينفذ لك ما أضمرت في قلبك ليكشف لك ما كتمت , ويعلن ما خبأت ويظهرك أمام نفسك على حقيقتكوالله سبحانه محيط علمه بكل ما كان وما هو كائن، وما سيكون، ولكن علمه علم حصر وإحاطة لا علم إلزام وإكراه.
يقول :
العدم ليس معدوما وإنما له كينونة من نوع ما، وقد كنت حقيقة في العدم تستجدي رحمة الله، فرحمك الله وألبسك لبسة الوجود، وكينونة العدم، كالفرق بين السالب والموجب، وبين الفاعل والقابل...وهذه العبارة بالذات، أرى فيها إغراقا بحيث أطلق فيها العنان للكلمات حتى أمكن أن توجد لهذه الكلمات كلمات أخرى تمدد المعاني إلى الإغراق المنبوذ الذي يتيّه ولا يرشّد ....ثم يشير الكاتب إلى أن توحيد أهل الإقرار يكفي المؤمن، إلا أن أن هذا العصر الذي صنع فيه العقل ما صنع، ولم يعد يقبل بالتسليم ...لم يعد بالإمكان فيه الإجابة بالتسليم لمن يسأل سؤال العقل والبحث، وأن ديننا دين العقل والسؤال والبرهان، ولا يردعنا عن السؤال إلا الخوض في ذات الله، وما عداها فيه مندوحة لأهل السؤال والبحث....
ثم يصل إلى ما يسميه بتوحيد أهل الأسرار، ويقصد به المعرفة الصوفية، ويقول أن غايتهم الشهود، وأن ذروة الشهود أن يشهد الإنسان عدمه، بمعنى الإقبال على الله بالتجرد الكامل حتى يرى العبد في نفسه العدم، ويرى الوجود كل الوجود في الله وحده ....ويقول أن هذا مقام الخاصة ...!
أما أنا فأقول في هذا، أن العقل يكفيه أن يدرك أن الله واجب الوجود سبحانه حي لا يموت، وأن العبد ممكن الوجود لأنه تجري عليه حياة وموت بأمر الله تعالى الذي أوجده من عدم...
أما الفصل الثالث فيفصل فيه عن توحيد أهل الأسرار وهذا شبيه بما أورده في كتابه "رأيت الله"، بل إن الكثير مما فيه مقتبس من كتابه ذاك، إلا أنه يبدأه بأن يجيب على سؤال: هل هناك ما سوى الله، بقوله: نعم وهو العدم، فما سوى الله عدم، وأنه الوجه المقابل للوجود كما تقابل الظلمة النور، وأن الله هو الوجود المطلق...
هنا يقول أنها نظرة ثنائية لا تنفي وحدة الوجود، ويقول أنها وحدة وجود إسلامية لا وثنية فيها، ولا دعوى مشبوهة فيها مثل دعوى "أنا الله"، بل إن العبد كان حقيقة كامنة في العدم سماتها الافتقار والعبودية، واللافعل، أسبغت عليها رحمة الله بإلباسها لبسة الوجود...
ثم يورد أقوالا لعارفين صوفيين، بحثوا في الذات والصفات، وأن الذات متعالية على الأسماء والصفات، والأسماء والصفات مفادة منها، ولكنها هي ذاتها فوق حدود التسمي وفوق حصر الصفات ...
وكذلك في هذا لافصل من الكتاب يحصل معي ما حصل معي في كتاب "رأيت الله" وأنا أقرأ عبارات صوفية موغلة في الوصف، والتشبيه .... ولم أجد فيها ما يقنعني أنها كلمات محدودة بحد، وأن صاحبها يعرف حدوده وهو يصف ما لا يوصف .... رغم أن الكاتب يخطئ نظريات الاتحاد ووالحلول، ووحدة الوجود، ويؤكد أن الله ليس كمثله شيء، إلا أنه يسوق عبارات الصوفية، وبعض أبياتهم على أنه توحيد أهل الأسرار ....! حتى يصل به الأمر إلى أن يقول أن الله ظاهر في كل المظاهر ولكنه منزّه عنها جميعا، وهو غيرها وإن قامت به . فيصل إلى وصف ظهوره فيها سبحانه وهو غيرها بالصورة في المرآة وهي غير صاحبها، والإنسان في المرآة دون حلول ودون اتحاد ودون انتقال فهو هو وليس هو ...!!
في الفصل الأخير وهو فصل بعنوان "
الوجود والعدم"
يلخص ما وصل إليه، من أن الإنسان كان في العدم يستجدي الوجود،وأن الله لا يجعل الإنسان قهرا كذا وكذا، وإنما كل ذات تحمل صفاتها وخصائصها... وفي هذا أرى أن أضع ما أورده حرفيا، لأنني لا أهضمه، ولا أفهمه، وأرى فيه فلسفة صعبة وفيها من الخطورة والله أعلم ....
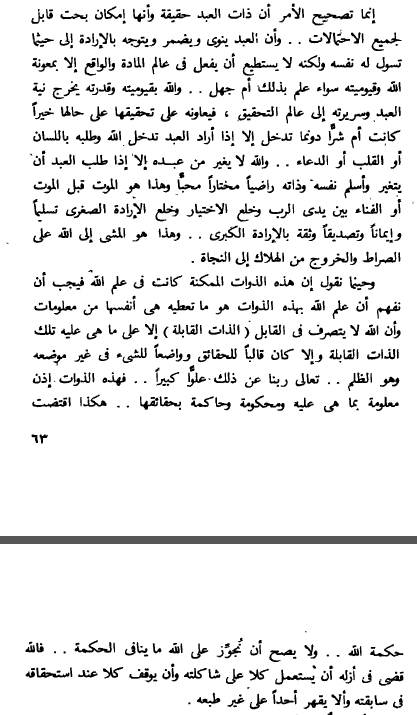
ثم يستطرد الكاتب مع الصوفية والتصوف، والعارفين منهم، حتى يورد قولهم أن أول من خلق الله هو النور المحمدي ...ثم يستطرد مع فصل آخر بعنوان "السير إلى الله" ويعني به سير الصوفية إليه، ويرى في قول النفريّ أن مبتدأ السير إليه بخلع النعلين !!! على أن النعلين هما النفس والجسد...!! وبقوله "أنا الله لا يدخل إلي بالأجسام ".....!!!! وهكذا يعيد ما ذكره في كتابه "رأيت الله" اقتباسا من هذ النفري الذي يقول أن التعرف إلى الله يبدأ بالعلم ثم بالمعرفة ثم بالأدب ......
وهكذا ينتقل الكتاب شيئا فشيئا من كلام وكلام وصولا إلى الصوفية على أنها توحيد أهل الأسرار...!!
فأرى الكتاب بالرؤية ذاتها التي رأيت بها كتاب "رأيت الله".... فأشد الرحال مرة أخرى عازمة، يحدوني الأمل أن أجد للدكتور مصطفى محمود شيئا غير هذا ....

فأتحول إلى كتابه "من أسرار القرآن".... أسأل الله أن ييسر لي كتابة شيء عنه لاحقا
